مغاربة إيطاليا بين غياب التمثيلية وتعثر السياسات: مقاربة في واقع مغاربة العالم وخطاب الإقصاء
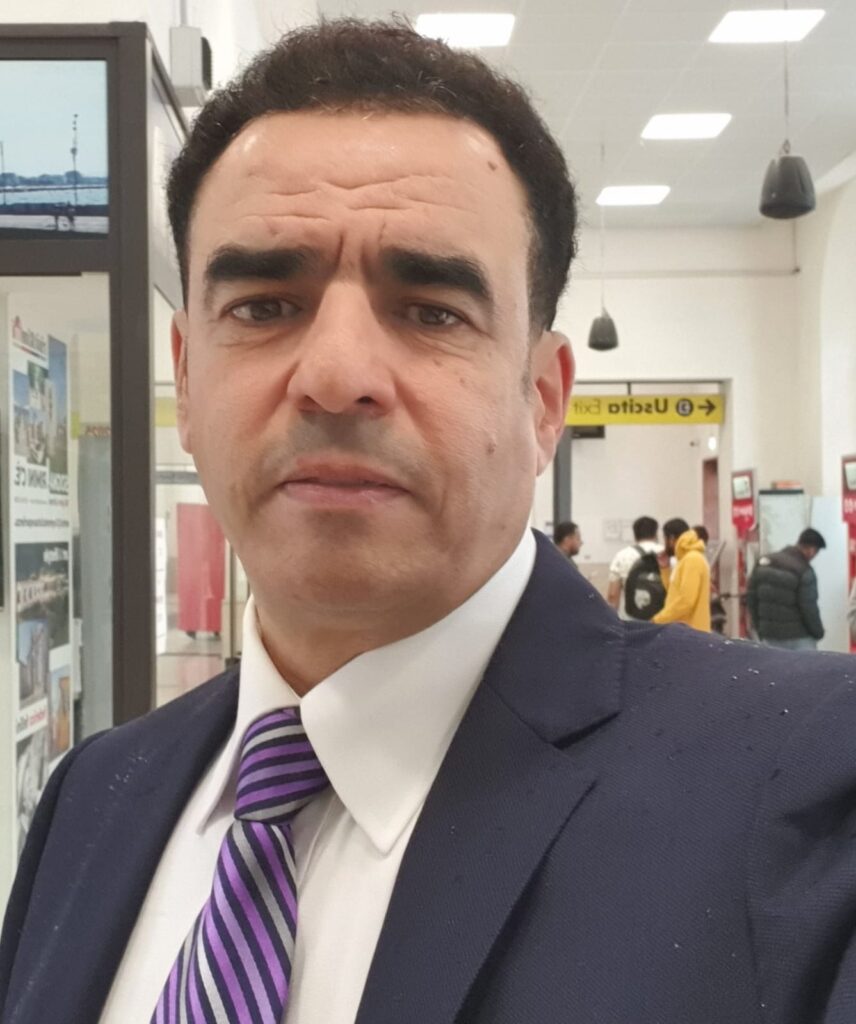
عبد الله مشنون
كاتب وصحفي مقيم بايطاليا
بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب؛ وجه جلالة الملك، تحية إشادة وتقدير، لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يبذلون كل الجهود للدفاع عن الوحدة الترابية، من مختلف المنابر والمواقع، التي يتواجدون بها. وضرورة الانتقال من الاعتراف الرمزي بمغاربة العالم إلى بلورة سياسات عمومية ومؤسساتية فعالة، تُعزز اندماجهم في المشوار التنموي الوطني، وترفع العراقيل التي تُضعف ارتباطهم العملي والوجداني بالوطن.
يتقاطع الخطاب الملكي مع المقال في تأكيده على:
¬ الاعتزاز بدور الجالية في الدفاع عن الوحدة الترابية.
¬ طرح أسئلة جوهرية حول مدى ملاءمة الإطار التشريعي والإداري لواقعهم.
¬ التنبيه إلى العراقيل التي تواجههم، خصوصًا فيما يتعلق بالإدارة والاستثمار.
¬ الدعوة إلى إشراك الكفاءات والمواهب في التنمية عبر آليات احتضان ومواكبة دائمة.
¬ الحاجة إلى مراجعة نموذج الحكامة المؤسساتي الخاص بهم من أجل فعالية أكبر.
وهذا يتناغم مع مضمون المقال الذي يشير إلى:
¬ شعور الجالية بالتهميش والإقصاء من السياسات الوطنية.
¬ غياب آليات مؤسسية فعالة ومستقلة لتمثيلهم.
¬ فشل الحكومة في الاستجابة لانتظارات الجالية، خاصة فيما يخص غلاء التذاكر، وتجميد وزارة الجالية، والتأطير الثقافي.
بالتالي، يشكل الخطاب الملكي مرجعية مباشرة تُعزز المشروعية النقدية للمقال، وتمنحه سندًا من أعلى سلطة في البلاد، يطالب بوضوح بتصحيح الاختلالات، ويطرح أسئلة عميقة لا تزال، للأسف، دون إجابات عملية.
يُعيد المقال موضوع مغاربة العالم إلى واجهة النقاش العمومي، انطلاقًا من وضعية الجالية المغربية في إيطاليا، حيث تتقاطع عدة أزمات متراكبة: الغلاء، ضعف التمثيل السياسي، الهشاشة المؤسسية، وغياب الرؤية الحكومية، لتُنتج في نهاية المطاف حالة شعورية جماعية من التهميش وفقدان الانتماء التدريجي.
لكن هل يمكن فهم هذا الشعور بوصفه مجرد انفعال عابر؟ أم أنه يعبّر عن اختلال بنيوي في منظومة العلاقة بين الدولة والجالية في الخارج؟ وهل تكفي الخطابات الرمزية، مهما بلغ صدقها، في معالجة قضايا ذات طابع هيكلي؟
من الزاوية التحليلية، يستند المقال إلى خلفية نقدية تُدين الفجوة القائمة بين التصور الرسمي خاصة الملكي منه والتجسيد التنفيذي الذي يُفترض أن تعكسه السياسات العمومية للحكومة والمؤسسات. فمن جهة، يُبرز النص الرعاية المتواصلة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لمغاربة العالم، سواء من خلال خطبه، أو عبر إحداث مشاريع مؤسساتية مثل المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم، وهي مبادرة وُصفت بأنها حاملة للأمل في إعادة الاعتبار لتمثيلية الجالية. لكن، ومن جهة مقابلة، تُطرح علامات استفهام كبرى حول مدى قدرة هذه المؤسسة المنتظرة على تجاوز منطق الزبونية السياسية وإعادة إنتاج نفس النخب، وهو ما يُعيد إلى الواجهة الإشكال الجوهري:
هل نحن بصدد مراجعة حقيقية، أم إعادة ترتيب للوجوه في نفس المشهد؟
في المقابل، يُحمِّل المقال حكومة عزيز أخنوش مسؤولية مركزية في ضعف الأداء المؤسساتي تجاه مغاربة الخارج. فغياب إجراءات ملموسة، وتجميد وزارة الجالية دون مبررات، وانعدام قنوات الحوار مع الفاعلين الحقيقيين، كلها مؤشرات تثير سؤال الإرادة السياسية:
هل يوجد فعلاً تصور حكومي متماسك لإدماج مغاربة العالم؟ أم أن التعامل معهم يظل محكومًا بهاجس موسمي انتخابي، لا يتجاوز خطاب النوايا؟
ولعل أبرز ما يلفت الانتباه هو التركيز على معضلة غلاء تذاكر السفر، لا بوصفها قضية مالية فقط، بل باعتبارها عائقًا هوياتيًا، يَحول دون ربط الأجيال الثانية والثالثة من أبناء الجالية بوطنهم الأم. هذا الربط الذكي بين الاقتصاد والثقافة والهُوية يُظهر عمق التحليل، ويفتح الباب أمام تساؤل جوهري:
إلى أي مدى يمكن للسياسات العمومية أن تُقوّي الانتماء الوطني، أو تُضعفه، من خلال قرارات تبدو في ظاهرها تقنية؟ وما الثمن الثقافي والنفسي الذي تدفعه الأجيال الجديدة في ظل هذا القطيعة الطوعية؟
في ضوء هذا، تتضح ملامح أزمة هوية حقيقية تعاني منها فئات واسعة من الشباب المغربي المقيم بالخارج، وهي أزمة متعددة الأبعاد: انقطاع عن اللغة، غياب تأطير ديني وثقافي رصين، تراجع الزيارات للوطن، وتحول الوطن نفسه – بفعل السياسات البيروقراطية والاحتكارية إلى فضاء غريب لا يحتضنهم إلا مناسباتيًا.
فهل هناك وعي رسمي بخطورة هذه القطيعة؟ وهل تدرك الدولة أن الجالية لم تعد فقط تحويلات مالية، بل رأسمال استراتيجي حيوي في سياق عالمي مضطرب؟
ثمّة نقطة أخرى يثيرها المقال بشكل غير مباشر، لكنها حاسمة: دور الجمعيات الجادة في أوروبا، وخاصة بإيطاليا، التي ما فتئت تبذل جهودًا ضغطية ميدانية، سواء عبر إطلاق مبادرات لخفض أسعار التذاكر، أو تقديم مقترحات تشاركية عبر القنوات الحزبية أو حتى شركات النقل. غير أن هذه الجمعيات تُحارب حسب المقال من طرف لوبيات مصالح، وهو تعبير يُحيل إلى واقع غير معلن تُدبّر فيه شؤون الجالية بمنطق الولاءات لا الكفاءات. هنا بالذات تطرح الإشكالية الجوهرية نفسها:
كيف يمكن بناء تمثيلية حقيقية لجالية تُقصى نخبها الصادقة وتُقصَف أصواتها النقدية؟
أما على مستوى التمثيلية السياسية، فيبدو أن الواقع أكثر قتامة. فبالرغم من الخطابات الملكية الصريحة الداعية لإشراك الجالية في الحياة السياسية، لا تزال مشاركة مغاربة الخارج في البرلمان والمؤسسات الدستورية غائبة، إن لم نقل مقصاة عمدًا.
فهل يُعقل أن يُحرَم ملايين المواطنين من الحق في الترشح والتصويت؟ وهل تعي الجهات الرسمية أن الإقصاء السياسي يُنتج بالضرورة لا مبالاة، إن لم نقل عداءً صامتًا للوطن؟ ومن يخشى فعلاً من وعي الجالية السياسي، وقدرتها على إحداث توازن جديد في ميزان القوى؟
بالمحصلة، لا يسعى المقال إلى تأليب الجالية على الوطن، بقدر ما يعبّر عن محاولة صادقة لإعادة بناء هذا الجسر العاطفي والمؤسساتي بين مغاربة العالم وبلدهم الأم. إنه لا يُدين الدولة، بل يسائلها: عن تمثيلية حقيقية، عن مؤسسات تستوعب الطاقات لا تصادرها، عن سياسات ثقافية حقيقية لا تُختزل في كعب غزال ولقاء شاي.
فهل نمتلك الجرأة لفتح هذا النقاش؟ وهل توجد في بنية الدولة من هو مستعد لسماع هذا الصوت؟
إن الجواب عن هذه الأسئلة لا ينبغي أن يُنتظر من المقال، بل من آليات الإصلاح نفسه، إذا أُريد له أن يكون جديًا لا فقط موسمياً.





تعليقات