العريف مبارك

عبد الغفور مغوار ، فاس
بخطى أثقلتها الهموم وتكاليف الحياة، كان العريف مبارك يقصد مرغما سوق مدينة طاطا المركزي، لجلب، بشكل أو بآخر، ما يمكن جلبه من مواد غذائية للاحتفال بعقيقة ابنه الذي مر على ولادته أكثر من أسبوعين، وذلك بعدما تلقى من زملائه المقربين مساعدة مالية لما أتيحت له الفرصة الآن لتحقيق بعض طلبات زوجته. ذاك المبلغ المحصل عليه في الحقيقة لم يكن كافيا لسد جميع الحاجيات، فلو أن زوجته وافقته الرّأي لسدد أولا واجب الكراء الذي تأخر عن تأديته ثلاثة أشهر، مقتصرا على ذبح شاة أو معزة لتسمية المولود، كما كان يصنع كل مرة، إلا أنه الآن لا يجوز هذا وهو: “العرييييييييييييييف مبارك”، على حد تعبير زوجته.
وهو في طريقه، كانت لا تزال تدوي بمسمعه تلك الكلمات القاسية التي واجهته بها زوجته وابنة عمه وكان لها وقع مؤثر في نفسه، جعلت الذكريات الأليمة تتصادم في ذهنه كذكرى وفاة أبيه وهو في رعيان صباه، وذكرى التحاقه بالجندية كعسكري بسيط وما واكبها من محن إلى أن تمت تسميته الأخيرة: العريف مبارك، والتي كانت لها قصة طويلة. فلو كان بطلها شخصا آخر في بلد آخر لكتب له الخلود في صفحات تاريخها ولما كان الحال على ما هو عليه مبارك المسكين.
فعلى الطريق المؤدية من طاطا إلى فم زكيد حيث ثكنته، وهو قادم ذات يوم من دواره، تم اعتراض الحافلة التي كانت تقله مع مجموعة من المدنيين وفيهم عدد من الشيوخ والنساء والأطفال، من قبل جماعة مسلحة متنكرة من البوليساريو وذلك في صيف سنة 1988. كان مبارك من الذين أسروا، بعد أن أشبع ضربا بمؤخرات البنادق والركلات لمحاولته الاستبسال شاهرا في وجه أحدهم سكينا، لتبدأ بذلك رحلة معاناته في جحيم الأسر. لما اختطفوه وهو فاقد الوعي، جعلوه تحت أقدامهم في سيارتهم، مكبلا معصب العينيين شبه عار، وكانوا يزيدون من إيلامه ونزيفه بتوجيهه ركلات ولكمات كلما صدر منه أنين. عند وصولهم صباح اليوم الموالي إلى معاقلهم، سحبوه كما تسحب الدجاجة ثم طرحوه مكبلا في خيمة من خيامهم. ظل مبارك ذاك اليوم بلا ماء ولا طعام. فراغ بطنه وحدة ألمه أخرجاه من غيبوبته، لكن انهيار قواه خذله فلم يقو على فك وثاقه أو حتى الصراخ لطلب الاستغاثة. وفي المساء دخل عليه رجال أشباه عفاريت فسألوه عن اسمه وعن نسبه. لم يتجاوب معهم فزودوه بجرعات إضافية من التعذيب.
أمروه إن كان يأمل في النجاة أن يسب ملكه وأن يتنكر لوطنه المغرب وأن يعاهدهم على الوفاء، لكنه لم يفعل إلا تحت طائلة من العذاب دام أياما وأياما، وهنت له قواه، حيث قد جربوا عليه كل ألوان الإذلال: جلدوه في ساحة من رمال وتركوه تحت لهيب الشمس جائعا لا يطعم إلا فتاتا، عطشانا لا يسقى إلا أجاجا، بل أكثر من هذا فإنهم كانوا يطفئون أعقاب سجائرهم في لحمه وهم يشتمونه وسائر أهله بأفظع الكلمات النابية. سب الملك إذن والوطن وذكرهم بخير وهو يتقطع في داخله حرقة وأسفا. فما كان لهم إذاك إلا أن بدلوا معاملته شيئا ما خصوصا لما علموا أنه يتقن مكانيك السيارات.
استطاع أن يوهمهم أنه سيخلص لهم ما داموا قد كفوا عن تحقيره فاعتبروه مرتزقا مثلهم. سموه “العبد”، وكانوا ينادوه في أكثر الأحوال: “ابن السوداء”. كان يرد على هذه التسمية بابتسامة عريضة تكشف عن نواجذه المتلألئة. مرت أيام بل شهور وهو يخدمهم في كل شيء: رعي، جلب الماء، إعداد الطعام وإصلاح السيارات التي كانوا يستعملونها في قطع الطرق داخل التراب الوطني. غير أنه لما أحس منهم الأمان بدأ يخطط لشيء خطير كله مجازفة، فشله فيه كان لا محالة سيؤدي به إلى حتفه، لكنه كان يقول في نفسه موتة على أيدي هؤلاء الأوغاد شهادة في سبيل الله وفي سبيل الوطن. ضل أياما عدة وهو يختلس من خزانات وقود سياراتهم بعض القطرات يخبؤها في آنية بلاستيكية لها سدادة، سعتها ثلاثون لترا، قد دسها في الرمال ببقعة مجاورة لورشته وهي عبارة عن عريشة، كان دوما يسكب ماء مستعملا في تلك البقعة حتى لا يجف البنزين داخل الإناء بفعل حرارة الشمس. كان يتحين فرصة فراره الذي كان يعتقد أنه سيكون مفخرة له ولأهله ولوطنه. من أمله الذي أملته عليه سذاجته كان يرى نفسه مستقبلا في موكب رسمي بشوارع طاطا محمولا على الأكتاف والناس يصفقون له ويهتفون باسمه، مما كان يقوي إصراره على الخلاص ويزيده تشبثا بخطته.
ذات ليلة، عاد خاطفوه أولئك المرتزقة وقد كانت غنائمهم كثيرة: قطعان من الماعز، نقود، ثمار، حبوب… عادوا بها إلى معاقلهم فشربوا احتفالا بنصرهم المزعوم “ماء الحياة” وغنوا ورقصوا كغجر برابري.
لما غلبهم النوم، وهمد ضجيجهم وسكنت حركتهم، كان حماس مبارك يلتهب في صدره حيث علته همة جعلته يهب إلى إحدى سياراتهم وهي من نوع “جيب” وأفرغ في خزان وقودها تلك الكمية من البنزين التي ادخرها لمثل هذا اليوم. ركب السيارة وجعلها تغادر ببطء حتى ابتعدت عن الموقع ببضع مئات الأمتار، ثم داس بقوة على دواسة البنزين فانطلقت السيارة مسرعة باتجاه حدود الوطن الذي أحبه كباقي المغاربة الشرفاء. لم ينظر خلفه كي لا يعلم إن كان يلاحقه أحد ما فيرتبك ويفشل ثم تضيع عليه الفرصة. أكثر من الدعاء والذكر. كرر تلاوة كل الآيات التي يحفظها. لم يكن في الحقيقة يعرف طريقه لكن حدسه قاده في ليلة ظلماء أشد حلكة من الليلة التي اختطف فيها إلى الحدود. ومع أول خيط لاح من الفجر لاحت أمامه من بعيد قوات ببدلات عسكرية تعترض قدومه شاهرين بنادقهم، كان فيلق من القوات المساعدة المغربية يستعد أفرادها إلقاء القبض عليه معتبرين أن القادم عنصرا من البوليساريو، لكن مباركا انتزع سترته ولوح بها خارج النافذة هاتفا:
- ” الله أكبر.. الله أكبر.. عاش الملك.. عاش الوطن.. الله أكبر…”
عند دنوه منهم، أقفل المحرك ونزل من السيارة رافعا يديه إلى السماء كإشارة استسلام وهو يكرر:” الله أكبر.. عاش الملك.. عاش الوطن …”. ثم خر ساجدا مقبلا ثرى بلاده.
داخل الثكنة، وفي حجرة من حجراتها المتواضعة، قص للقادة ما جرى له بداية من الاختطاف إلى الفرار.
وانتهى الأمر في صمت برسالة من أركان الحرب، قد تأخرت طويلا طويلا، أعلن فيها عن ترقية الجندي الأول مبارك إلى درجة عريف، فتلقى بذلك من رؤسائه تهنئة متواضعة. لكن العريف ظل يؤمن بأنه بطل يستحق التكريم بأكثر من هذه التسمية، فقد يأتي يوم سيكرم فيه والعديد من أمثاله الذين ذاقوا مرارة الأسر في مخيمات العار.
الأسعار هذا اليوم كانت عالية، لذا البطل العريف مبارك لم يجد بدا من أن يعود إلى بيته خائبا مدحورا كما خرج منه أول الأمر. أما كلام زوجته، فقد تعود بأسره على ما هو أكثر منه احتقارا وإهانة، ومسا للكرامة، في وقت كان فيه كم من خائن منعما كل النعيم لا يعرف للجوع طعما.



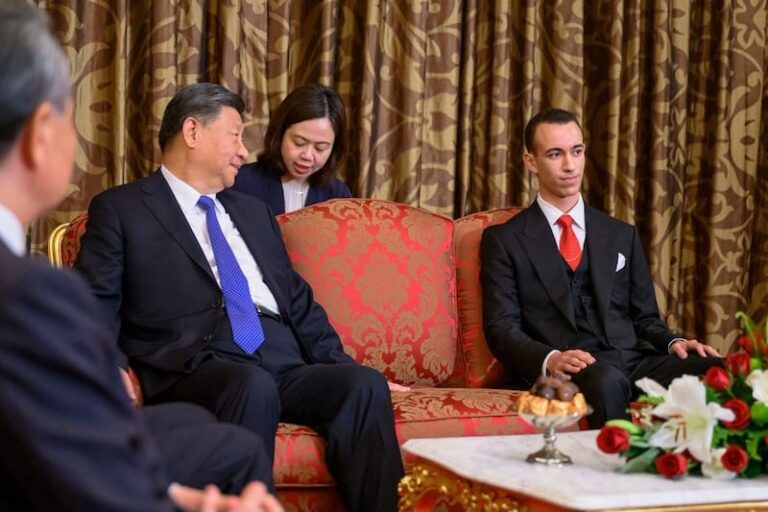

ممتاز
اسلوب و حبكة جميله
اسلوب و حبكة جميلة